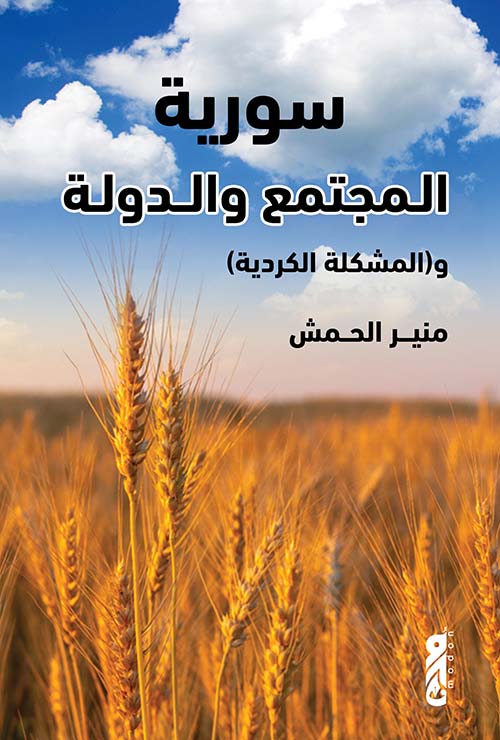
كتاب: سورية: المجتمع والدولة و(المشكلة الكردية)
تأليف: الدكتور منير الحمش، مراجعة: الدكتور البير داغر، استاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية
كتاب: سورية: المجتمع والدولة و(المشكلة الكردية)
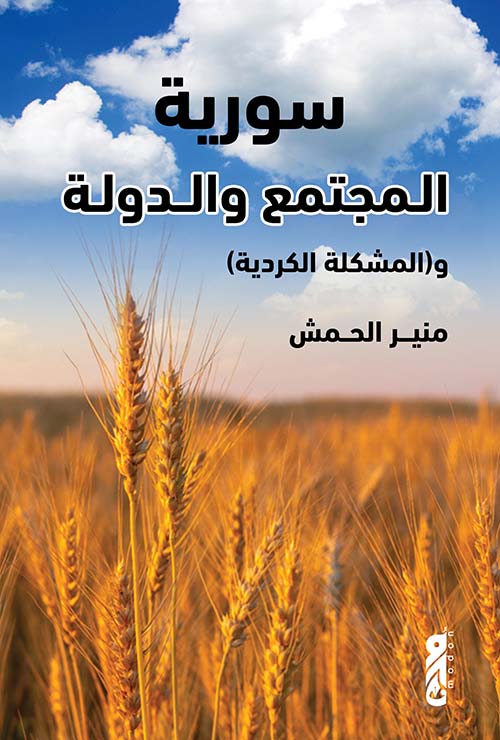
تأليف: الدكتور منير الحمش
مراجعة: الدكتور البير داغر، استاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية
بدأ الكاتب بالتساؤل لماذا لم تنجح سورية كجزء من المشرق العربي في التصدي لإصرار الغرب على اعتبارها ساحة نفوذ له والعمل على إضعافها وتعميق تبعيتها له. أي استمرار “المسألة الشرقية” بصيغتها المعاصرة. ووجد أن الجواب يكمن في الإجابة على أسئلة الدولة والهوية والاقتصاد والسلطة وإدارتها (ص 17). وتوزّعت مادة الكتاب على أربعة فصول هي تأسيس سورية والتحديات، والمجتمع والدولة في سوريا، والاقتصاد السياسي للأزمة والحرب، والمشكلة الكردية.
– في الفصل الأول حول التأسيس والتحديات (ص 25 – 80)، تناول الكاتب موضوعين هما إشكالية تأسيس الدولة السورية وما يسميه جدل الدولة والهوية والانتماء والسيادة في سورية المستقلة. وقد فعل حسناً في التمهيد لهذا الفصل بعبارة قالها جنرال فرنسي بعد تجزئة المنطقة، من أن “المسألة الشرقية هي مسألة أبدية” (ص 24). بمعنى أن تجزئة المنطقة والتعاطي معها كساحة نفوذ للكل سيحدد مصيرها في المستقبل كما كان الأمر في الماضي.
وقد تأسّست الدولة و”تحمل في طياتها بذور مشكلات الحدود والهوية والانتماء”. وهي على خلاف الدولة الغربية المنبثقة من مؤتمر وستفاليا لم تكن قادرة على امتلاك سيادتها ولم يكن تشكيلها نابعاً من الداخل السوري. وهناك وقائع حول مؤتمري سيفر ولوزان والانتداب الفرنسي وتعاطي الاميركيين آنذاك مع سايكس – بيكو وحالة التخلف التي كان يعاني منها الكيان الجديد والموقع الذي حددته المصالح الفرنسية لدور سورية.
وفي مسألة الدولة والهوية والانتماء الوطني والسيادة، ذكّر الكاتب بمحاولة سلطة الانتداب تجزئة سورية الحالية وتصدي السوريين لذلك. وهناك عودة إلى كتابات أنطونيو غرامشي حول دور الدولة ووظائفها وعودة إلى نزيه الأيوبي في تعريف الدولة بالاستناد إلى غرامشي نفسه وماكس فيبر (ص 46).
وفي قضية فلسطين والصراع العربي- الصهيوني، رأى الكاتب أن قضية فلسطين كانت الشغل الشاغل للشعب العربي السوري ومحور السياسة السورية منذ الاستقلال. واستعاد جملة من الأفكار والوقائع حول الحركة الصهيونية. واستعاد وقائع من مواجهة الفلسطينيين للاحتلال البريطاني والهجمة الصهيونية في آن معاً وصولاً إلى اعلان قيام دولة اسرائيل. وهو الاعلان الذي وافق عليه الاتحاد السوفياتي من ضمن صفقة مع اسرائيل (ص 59). وقد شكلت القضية الفلسطينية مذ ذاك همّاً وطنياً سورياً (ص 57).
وفي الصراع على المنطقة العربية عموماً وعلى سورية بوجه خاص، أظهر الكاتب الوقائع التي تُظهر أهمية المنطقة لجهة وجود النفط فيها، وكيف أنها تحوّلت إلى ساحة مواجهة بين الجبارين وإلى منطقة تدخّل أميركي سافر في شؤونها. وأورد وقائع حول الصراع القائم على سورية بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي مسألة الخيار الاقتصادي والاجتماعي وبناء اقتصاد مستقل لسورية، ذكّر الباحث بالانفصال الجمركي عن لبنان وتحرير النقد السوري من السيطرة الاجنبية وتأميم شركات انتاج الكهرباء الفرنسية وحماية وتنظيم الانتاج الزراعي والصناعي وتطوير الاقتصاد الوطني. وقد جاء العرض في هذا الباب مختصراً ومقتصراً على بضعة عناوين (ص 75). وهو موضوع كان يستحق في هذه الاستعادة للتجربة السورية أكثر من ذلك.
وتحت عنوان، “قرن من المآسي والاحباطات مضى: ماذا عن القرن الجديد؟”، ذكّر الباحث أن سورية حملت شعارات المشروع النهضوي العربي وتعرّضت للأذى بسبب تمسكها بأهداف هذا المشروع (ص 79). ورأى أن ثمة انتقالاً من نظام وحيد القطبية إلى نظام متعدد الاقطاب، وأن سورية تقع على نقطة تماس بين نظام آفل ونظام يولد.
– في الفصل الثاني حول المجتمع والدولة في سورية (ص 81 – 194)، وتحت عنوان “تمهيد في المفاهيم”، تناول الباحث بالشرح مقومات المجتمع الحديث مع الإحالة إلى كتابات ابن خلدون وحليم بركات حول المجتمع العربي (ص 83) وحازم ببلاوي حول دور الدولة في الاقتصاد (ص 85) وعبد الله العروي حول مفهوم الدولة (ص 88). وتناول مسألة سيادة الدولة ثم العولمة وأثرها السلبي. وأحال في موضوع الاصلاح والعقد الاجتماعي، إلى كتابات السيد ياسين حول الدولة العربية مشيراً إلى استقالة الدولة العربية التدريجية من أداء وظائفها التنموية وترك الحرية لقوى السوق وتراجع الرعاية الاجتماعية (ص. 99).
وفي نشأة الدولة السورية الحديثة وهويتها، تناول الكاتب مسألة التجزئة للمنطقة التي فرضها الاستعمار مع إحالات إلى أعمال عبد الله العلايلي ومسعود ضاهر وغسان سلامه وكتاب الباحث نفسه الصادر عام 2004. ورأى أن سورية عبرت في مناسبات مختلفة عن التزامها بالإنتماء العربي (ص 108) وأن ذلك انعكس في مواقف الغرب تجاهها والحصار الاقتصادي الذي فرض عليها.
وفي السمات العامة للمجتمع السوري كمجتمع عربي، أورد الباحث رأي الكاتب حليم بركات حول كونه قائماً على بنية انتاجية متمركزة حول العائلة مع ظهور النظام الريعي ومع التبعية إثر اندماجه في النظام العالمي وأنه يعاني النزعة الاستبدادية على مختلف الأصعدة ( ص110). كما أورد رأي هشام شرابي حول نشوء مجتمع جديد وهجين من الاجتماع وفي الثقافة (ص 112). وتناول الهوة الواسعة التي تفصله عن المجتمعات الصناعية المتقدمة، وعرّف الشرائح الاجتماعية والطبقية مع تتبع لتطورها خلال مرحلة الانتداب ومرحلة الاستقلال ومرحلة الوحدة ومرحلة الانفصال ومرحلة السبعينيات والثمانينات والتسعينيات وصولاً إلى مرحلة الاصلاح الاقتصادي (2000-2005). وقد أثّرت السياسات الموالية للفئات الثرية ولرجال الاعمال الجدد على التركيب الطبقي في سورية. وهو ما أشارت إليه التقارير عن الفقر والتمايز الطبقي (ص 129).
وفي مقومات المجتمع السوري، أورد الباحث وقائع ومعطيات حول البيئة والسكان والقوى العاملة وواقع الطبقة الوسطى بعد 2011. وأورد وقائع فادحة نقلاً عن تقرير الإسكوا حول سورية (ص 149). وتناول النظام السياسي والاقتصادي مروراً بمرحلة الانقلابات والحركة التصحيحية وبيّن توزّع السلطات فيه. وعرض المبادئ الاقتصادية التي عمل بها النظام وعبّر عنها الدستور وأظهر ماهيتها في المجال الاجتماعي وفي التعليم وفي الثقافة. وذكّر بالمبادئ الاساسية للدستور (ص 161).
وذكّر بأن أهم ما جاء في دستور عام 2012 الجديد، هو التغيير الذي تضمّنه في المبادئ الاقتصادية مقارنة بما كان عليه الأمر في دستور 1973 (ص 165). وقد جرى استبعاد كلمة “اشتراكية” منه وعكس ميلاً إلى السياسات الموصى بها من المؤسسات الدولية. وأورد الكاتب جزءاً من النقاش الذي أثاره مشروع الدستور خصوصاً حول هوية سورية العربية وصلاحيات رئيس الجمهورية.
واستعرض الكاتب تحت عنوان الاحزاب السياسية في سورية (ص 169)، تيارات الفكر الاوروبي والتيار القومي العربي وتيار الفكر الاسلامي. وقدّم عرضاً جزئياً لتاريخ هذه الأحزاب وصولاً إلى “التجمّع الوطني الديمقراطي” وصدور قانون ينظّم الترخيص للأحزاب بعد 2011. وقد تناول في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل، منظمات المجتمع المدني بكل تعابيرها وتشعباتها (ص 178- 194).
– في الفصل الثالث حول الاقتصاد السياسي للأزمة والحرب (ص 195- 273)، قدم الباحث لهذا الفصل بفقرة مقتبسة من تقرير الحكومة السورية حول الخطة الخمسية العاشرة (2006-2010) جاء فيه أن ثمة “تحوّل في الهياكل الاقتصادية جعل سورية أكثر انفتاحاً وتنافسية واندماجاً في الاقتصاد العالمي مع تغيير واسع في دور الدولة” (ص 195). وأوضح معنى ذلك في الانتقال الذي تم نحو الليبرالية الاقتصادية الجديدة الذي كان عنوان المرحلة. والفصل تناول حقيقة ما جرى وتلمّس بعض الحلول للمستقبل.
وتحت عنوان ماذا تريد الولايات المتحدة من سورية، استعاد الباحث حضور الولايات المتحدة منذ تقرير لجنة كينغ-كراين مروراً بأول انقلاب كانت وراءه في 1949 ثم تصاعد التدخّلات خلال الخمسينيات. وهناك تتبّع للوقائع من سبعينيات القرن العشرين حتى آخر القرن يطغى فيه تعقب السياسة الاميركية في العالم وفي المنطقة، ومتابعة لهذه السياسة بعد 2001 وخصوصاً بعد 2003 تحت عنوان الضغوط السياسية والعقوبات الاقتصادية ضد سورية.
وتحت عنوان اشكالية الدولة السورية القطرية والحاجة إلى دولة وطنية قوية (ص 216)، أشار الكاتب إلى أن نشأة الدولة كانت مختلفة عن النموذج الغربي وجاءت بعد سقوط السلطنة العثمانية وفقاً لإرادة القوى العظمى. واستعاد هذه التجربة على مستوى سورية منذ معاهدة سيفر وقال أن الحفاظ على الدولة العربية السورية هو واجب وطني وقومي (ص 225).
وتحت عنوان الإطار النظري لدور الدولة الاقتصادي، قدّم الكاتب عرضاً حول المدارس الاقتصادية المختلفة مروراً بالكينزية ودولة الرفاه وصولاً إلى الليبرالية الجديدة وتوافق واشنطن. وتناول العرض موقعي السوق والدولة في مختلف هذه المدارس والأحقاب. ثم تناول دول العولمة على حدة وأثرها السلبي على الدولة، معتمداً إحالات إلى نصوص لـ اسماعيل صبري عبد الله وجلال أمين والسيد ياسين. وخلُص إلى أن العولمة أصبحت مصدر التهديد الأساسي لسيادة الدول (ص 252).
وتحت عنوان الأزمة / الحرب في سورية (ص 254 – 273)، ذكّر أولاً بأسباب نشوب الأزمة، وهي سياسة الانفتاح الاقتصادي المتسرّع وإهمال الأرياف والداخل والتحوّل إلى اقتصاد ريعي قائم على الخدمات والسياحة والمضاربات على حساب الاقتصاد الحقيقي، وتنازل الدولة عن دورها المركزي في ادارة الاقتصاد. وتناول ثانياً العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي بدءاً من قانون محاسبة سورية عام 2003. وأشار إلى تدهور الأوضاع الانسانية والاجتماعية وتعطيل القاعدة الاقتصادية وتدهور رأس المال البشري والمادي الناجم عن ذلك.
وتحت عنوان تحديات ما بعد الأزمة (ص 259 – 263)، رأى أهمية توفير الأمن الشخصي للمواطنين ونزع السلاح وإعادة إدماج المهجّرين وإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة وبناء اقتصاد قوي لمواجهة اسرائيل وتفكيك العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.
وفي سياسات ما بعد الأزمة (ص 263- 269)، رأى ضرورة اعتماد رؤية تنموية تنطلق من إعادة الدور التنموي للدولة وزيادة الإنفاق الاستثماري العام والحد من تقلبات سعر الصرف وإعادة النظر بسياسة التجارة الخارجية لحماية الصناعة ودعم التصدير. ورأى ضرورة تأهيل وإنشاء مؤسسات حكومية قوية وقادرة على ادارة وتوجيه السياسات الاقتصادية وضرورة تحفيز القطاع الخاص والتخطيط الاقتصادي.
– في الفصل الرابع حول المشكلة الكردية (ص 274 – 373)، تناول الباحث على مدى نحو مئة صفحة تفصيل هذه المشكلة في سورية. وهو متضلّع في هذا الموضوع. وقد تناول الجذور التاريخية للمشكلة ونشوئها (ص 279)، وعرض الوقائع المتعلقة بها من سيفر إلى لوزان (ص 282). ثم عرض تطورات المسألة الكردية في تركيا، والهجرات الكبرى إلى سوريا، وبروز ثم سقوط المشروع الفرنسي التقسيمي (ص 296). ثم تناول حركة العصيان التي قام بها الاكراد ولاحقاً انتهاء التحركات الانفصالية (ص 308). واستعاد الوقائع حول نشوء حزب العمال الكردستاني (ص 326). واستعاد أخيراً الوقائع حول الدور الاميركي التقسيمي الجديد (ص 331)، وحول الابعاد الجيو-سياسية للمشكلة (ص 336)، كما مشروع الادارة الذاتية في الجزيرة (ص 344). والفصل برمته مفيد لجهة المعلومات والعرض التاريخي الذي قدمه ولجهة التأكيد على الموقف الوطني والقومي العربي حول هذه القضية. وأنا مصرّ على أن هذا الفصل كان ينبغي أن يصدر في كتاب مخصّص له على حدة.
– يثبت هذا الكتاب هو الآخر أنه لا يمكن قول شيء مفيد حول التجربة العربية ومنها التجربة السورية بدون الانطلاق من كيفية انخراط كل دولة عربية في العلاقات الدولية، ومن دون الانطلاق من السياسات الداخلية خصوصاً الاقتصادية التي اعتُمدت في كل بلد. وقد أخذت المعالجات التي تتناول العلاقات الدولية لسورية وتلك التي تتناول السياسات الاقتصادية المتبعة فيها المساحة الأكبر مقارنة ببقية الموضوعات التي تناولها الكتاب.
————————
